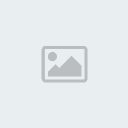واحدة من العمليات المخابراتية القذرة، المنصرفة إلى أعمال القتل والتخريب، وبث الشقاق والعداوة، وزعزعة الاستقرار الداخلي بإشعال الفتن والضغائن بين العشائر.
تلك المهام لا يتولاها أي شخص، بل تختاره الأجهزة المخابراتية وفق شروط صعبة معقدة، حيث يُخضع لدورات تدريبية أشد تعقيداً عن تلك التي ينالها الجاسوس المكلّف بجلب الأخبار، يُغسل تماماً من مشاعر الإنسانية، تُنزع من قلبه مشاعر الحب والشفقة والندم، وتُزرع مكانها الغلظة والقسوة والجفاف، تُخنق عواطفه الفطرية فيتحول بعد ذلك إلى مخلوق بلا قلب، يتحرك الوحش الكامن فيه بالأمر، ويسكن بداخله بالأمر أيضًا.
عام 1965، عُقد مؤتمر القمة العربية في القاهرة، الذي تقرر فيه تحويل روافد نهر الأردن، وبُحثت فيه الإجراءات العسكرية الواجب اتخاذها لمواجهة أي رد فعل إسرائيلي ضد عمليات التحويل، فقدمت القيادة العربية المشتركة خطة موحدة حددت فيها الإمكانات العسكرية التي يجب أن تتوافر لدى كل دولة من الدول العربية المتاخمة لإسرائيل، حتى إذا ما وقع أي هجوم إسرائيلي يتصدى له رد جماعي عربي.
كان نصيب لبنان من تلك الخطة سرباً من الطائرات وراداراً، على اعتبار أنه يملك مناطق استراتيجية عسكرية مهمة على رؤوس قمم الجبال. وخوفاً من وقوع هجوم عليه يدمر طائراته وراداره، تقرر إعطاؤه أيضاً بطاريات صواريخ أرض/ جو، وبعد أن وزّعت الخطة انتقل البحث إلى التكاليف وتحديد الجهات العربية التي ستتولى التمويل، بحيث تكون لديه صواريخ نقالة لا تكون عرضة لعمليات نسف إسرائيلية. قوبل هذا التبدل في السياسة والتسليح بغضب أميركي.
خلال عامي 1971و 1972، عاش لبنان مأساة الخلاف مع الفلسطينيين، ووقعت حوادث مايو (أيار) 1973 وتدهورت علاقاته مع الدول العربية، لكن تلك السياسة ما لبثت أن تبدلت بعد ذلك، وبعد حرب أكتوبر انفتح لبنان على العرب وعلى المقاومة الفلسطينية، ورأى أنه لا بد من التنسيق مع العرب والمقاومة للذود عن أجوائه وسيادته. تجلت تلك السياسة الجديدة بذهاب الرئيس سليمان فرنجية إلى الأمم المتحدة ليقول كلمة العرب في القضية الفلسطينية، وتجلت أكثر بتخلي لبنان عن فكرة إخلاء المخيمات الفلسطينية من الأسلحة الثقيلة، وساد شعور ضمني بأن هذا السلام في المخيمات هو قوة للبنان واللبنانيين.
لم تقف إسرائيل ساكنة أمام تلك التغييرات، فقد استشعرت بأن لبنان بدأ يسير بخطى ثابتة للانتقال من مرحلة الدولة المساندة إلى مرحلة الدولة المواجهة.
التغيّر اللبناني بينما كانت تتشكّل خطوط السياسة اللبنانية الجديدة، كانت إسرائيل تراقب بقلق وحذر، فمن شأن لجوء لبنان إلى «الشرق» متلاحماً مع دول المواجهة فتح جبهة عربية خامسة ضد إسرائيل، تضطرها إلى تغيير استراتيجيتها العسكرية كلها، ويحل بذلك السخط الإسرائيلي والأميركي على لبنان.
لكل ذلك، أعطت أميركا الضوء الأخضر لإسرائيل لتعربد في لبنان وتضرب النبطية ضربات مستمرة متلاحقة، ويتسع نطاق ضرباتها لتشمل مخيمات اللاجئين حتى في بيروت نفسها.
بدأ دور المخابرات الإسرائيلية في عرقلة التطورات اللبنانية، وقطع خطوط التوافق والتمازج بين لبنان والعرب، باللجوء الى أسلوب شبكات التخريب، حيث رأت أنه الحل الأسرع والأسهل، ذلك لأنها جرّبته كثيراً ونجحت فيه، ولها عشرات السوابق في ذلك أهمها فضيحتي «لافون» وتهديد علماء الصواريخ الألمان وقتلهم في مصر.
لذلك جندت اسرائيل اللبناني خميس أحمد بيومي (34 عاماً) ودربته على أن يكون جاسوساً بلا قلب، منزوع المشاعر وحشياً في إجرامه، لتنفيذ سياستها التخريبية في لبنان والضرب بلا رحمة في الصميم.
عزيز قوم ذل فى إحدى البنايات المطلة على البحر مباشرة في طريق بوليفار، ولد خميس لأسرة ميسورة جداً وافرة العدد، فوالده مقاول كبير يملك مكتباً فخماً يموج بعشرات الإداريين، وفي محيط هذا الثراء عاش مدللاً مرفهاً ومنعماً، لا يعلم من أمر الدنيا سوى اللهو والسهر في مقاهي بيروت وصيدا برفقة من يماثلونه ثراء، فقضى سنين عمره بحثاً عن المتعة ومطاردة الحسان، متجاهلاً نصائح والده الذي فشل في الاعتماد عليه في إدارة أعماله، فتركه لحاله يائساً منه، غاضباً عليه، على أمل أن يأتي يومٌ ويفيق إلى نفسه.
لكن أمله لم يتحقق في حياته، إذ مات فجأة في حادث سيارة، وتبين لأسرته أنه مدين بمبالغ طائلة للبنوك، وأفاق خميس على واقعه المؤلم وقد صفعته الصدمة وزلزلته الكارثة، خصوصا وقد تهرب منه أصدقاء السوء فوجد نفسه فجأة العائل الوحيد لأمه وإخوته الستة، وكان عليه أن ينبذ ماضيه ليقيهم مرارة الفقر والعوز والمعاناة.
عمل خميس اختصاصياً للعلاج الطبيعي في أحد مراكز تأهيل المعوقين في صيدا، وبعد مرور أربع سنوات في العمل، اكتشف أنه مثل الثور الذي يجر صخرة يصعد بها إلى الجبل، وفي منتصف المسافة تنزلق الصخرة، فيعاود الكرة من جديد من دون أن يجني سوى الشقاء، لذلك كره نفسه وواقعه، وفكر فى الهجرة إلى كندا وبذل جهداً مضنياً لكن محاولاته فشلت، فخيمت عليه سحابات الغضب واليأس، وانقلب إلى إنسان عصبي وعدواني، وأصبح مخلوقا ضعيفا عاجزا عن المقاومة وسط حالة الفشل التي تلفّه من الجهات كافة.
في شباك الجاسوسيّة ذات صباح التقى خميس بسيدة أرمينية مسنّة، جاءت لتسأله عن إمكان عمل علاج طبيعي لابنتها المعاقة في المنزل، وأعطته العنوان لكي يزورها بعدما أطلعته على التقارير الصحية التي تشخّص حالتها.
وجد خميس في حديثها وملبسها علامات الثراء، فزار منزلها حيث كانت ترقد «غريس» بلا حركة، طفلة في التاسعة من عمرها في عينيها شعاعات الأسى والبراءة.
ظل خميس مداومًا على زيارتها للعلاج إلى أن التقى بخالها «كوبليان» تاجر المجوهرات في بيروت، فتجاذبا معاً أطراف الحديث، وقص خميس حكايته مع الثراء وليالي بيروت، وصراعه المرير مع الفقر لينفق على أسرته، وسأله كوبليان سؤالاً محدداً، عن مدى قدرته على الإقدام على عمل صعب بمقابل مادي كبير، فأكد خميس استعداده لعمل أي شيء في سبيل المال.
سافر كوبليان إلى بيروت وقد خلف وراءه صيداً سهلاً، ضعيفاً، يكاد يفتك به قلق انتظار استدعائه، وما هي إلا أيام حتى فوجئ كوبليان بقدوم خميس يرجوه أن يمنحه الفرصة ليؤكد إخلاصه، فهو ضاق ذرعاً بالديون والحرمان ومتاعب الحياة.
رحب به عميل الموساد واحتفى به على طريقته، وهيأ له الفرصة لكي يجدد ذكرياته أيام الثراء، ولم يكن الأمر سهلاً بالطبع فسرعان ما انجذب خميس لماضيه، وترسخت لديه فكرة العمل مع كوبليان كي لا يُحرم من متع افتقدها.
كانت آلاف الليرات التي تُنفق عليه دافعاً الى زيادة ضعفه وهشاشته، ونتيجة لحرمانه لم يعارض مضيفه في ما عرضه عليه، وكان المطلوب منه حسب ما قاله، تهديد المصالح الأميركية لموقفها مع إسرائيل ضد لبنان، وضد العرب، ولما أعطاه خمسة آلاف ليرة – دفعة أولى – قال له خميس إنه مع النقود ولو ضد لبنان نفسه.
( يتبع )