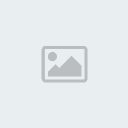جريمة ، إنما في حب الحسين بن علي
شبكة المنصور
علي الصراف
رجل المافيا يقتل أقرب أصدقائه إليه، بأبشع الصور، وأكثرها ميلا للانتقام. وعندما يعود الى البيت، يغسل يديه، ويعيد تصفيف شعره، وإذا رأى أمه فانه يتقدم ليقبّل يديها بخشوع.
مجرم، ولكنه ورع أيضا.
يمارس أكثر الأعمال وحشية، ولكن لا تفوته زيارة الكنيسة كل أسبوع، ويقدس القيم العائلية.
هذا هو المليشياوي الشيعي المثالي.
وهو كلما زاد قربا من الحسين بن علي بن ابي طالب، كلما زاد استعدادا لأعمال القتل.
انه يسفك دماء أقرب الناس إليه، إلا انه مؤمن في الوقت نفسه.
يذبح الأبرياء على الهوية، لمجرد أنهم سنة، إلا انه يتمثل "تضحيات الإمام الحسين" ويبكي بحرقة في مواكب العزاء عليه.
وهو يذهب الى مواكب التطبير ليُغرق نفسه بالدم، ولكن من اجل أن يجعل مسيل دمه حافزا لسفك دماء الآخرين.
يرى دمه، ليسهل عليه أن يرى الآخرين مضرجين بدمائهم.
وهو يتباهى بدمه، كدليل على مدى حبه للحسين، ولكن من خلاله يرفع سقف الجريمة. فحب الحسين يحميه، ويطهر روحه. وكلما ازدادت جرائمه بشاعة، كلما زاد بكاؤه على الحسين حرارة.
وكلما تعمق الغلُّ في صدره ضد الآخرين، كلما لطم على الحسين أكثر.
والمليشياوي الشيعي، خريج المدارس الصفوية الايرانية، لا يكتفي بالقتل والاغتصاب، ولكنه يدرك بعمق، انه حتى وان كان يفعل ذلك لإشباع رغباته الشاذة، فانه يفعل ذلك "حبا للحسين" و"دليلا على الولاء لآل البيت".
وما قد يبدو "ازدواجية" مروعة في السلوك، ليس كذلك بالنسبة له. فحب الحسين يُرخّص له كل شيء.
في حب الحسين، مثلا، يمكن التحالف مع الولايات المتحدة، من اجل اكتساب السلطة.
في حب الحسين، يمكن تشكيل فرق موت لملاحقة مناهضي الاحتلال.
في حب الحسين، يمكن تشكيل مليشيات طائفية تمارس الترويع وكل ما تشاء من أعمال القتل والنهب.
في حب الحسين، يمكن توقيع اتفاق أمني مع الولايات المتحدة، والتظاهر ضدها.
في حب الحسين، يمكن قتل اللاجئين الفلسطينيين وطردهم من منازلهم في بغداد، والدعوة لمقاطعة إسرائيل.
في حب الحسين، يمكن نهب الأموال واغتصاب النساء، على اعتبار أنها نوع من "الخُمس".
وفي حب الحسين، يمكن اغتصاب حتى الفتيات الشيعة في فرق "الزينبيات"، على أساس أن السيدة زينب كانت مثالا في ما لا يمكن قوله.
هذا "التضارب" لا يبدو تضاربا في عين المليشياوي الشيعي. انه جزء من طبيعة الأشياء.
الأشياء لا تكون واضحة في ناظريه، ما لم تكن هكذا أصلا.
وهذا ليس من دون سبب.
في الواقع، يوجد سببان، تاريخي وفقهي، لهذا السلوك.
إظهار الحب للحسين، كان من الناحية التاريخية غطاءً لواحدة من أبشع أعمال القتل والتصفيات الجماعية التي ارتكبت ضد البشر.
الاحتفال بذكرى مقتل الحسين، وتمثيل "موقعة كربلاء"، لم يبدأ إلا في القرن السادس عشر في إيران الصفوية. وكان الشاه إسماعيل الصفوي هو أول من استخدام هذا التمثيل لنشر المذهب الشيعي في فارس، إنما بعد أن شن حرب إبادة طائفية ضد الأقليات الإيرانية السنية، قتل خلالها الملايين واجبر أيتامهم وأحفادهم على تبني المذهب الشيعي.
تلك الجرائم ما كان لها أن تجد ستارا إلا بالزعم أنها تعبير "عن الحب للإمام الحسين".
وبفضل هذا "الحب" لم تتم التغطية على الجريمة بغطاء نبيل فحسب، ولكن تم رفع سقفها أيضا بحيث تحولت الى أعمال تطهير ما تزال مستمرة الى يومنا هذا.
معظم الأقليات الإيرانية صارت هي الأخرى "تحب الحسين". وصار الشيعة يمثلون 80% من مجموع السكان. وكلهم غارقون بالحب، الى درجة أنهم بدأوا بنشر حربهم الطائفية الى دول الجوار، وبخاصة ضد السنة في العراق.
وهي حرب ليس كمثلها حرب. قتل على الهوية. وجثث ترمى في الشوارع. وحواجز كونكريتية بين الأحياء. وحرمان وتجويع وتهجير طال فعليا ربع مجموع السكان، وذلك فوق مئات الآلاف من المعتقلين.
وإذا سألت، لماذا؟
قيل: حبا في الحسين!
وليس عن عبث يتم تقديم السنة العراقيين على أنهم "أقلية"، مع أنهم ليسوا كذلك. فسحق الأقليات أمر مألوف في تاريخ الحروب الصفوية. والـ"أقلية" تعني، بالنسبة لهذا التاريخ، شيئا صغيرا ومعدوم الأهمية ويمكن التضحية به.
ولا يقال انهم يفعلون ذلك حبا بالمال والنفوذ والسلطة، ولكن يقال انه "في حب الحسين".
وبعد الشاه اسماعيل، واصل الشاه عباس الصفوي (توفي عام 1629) تمثيل واقعة كربلاء، لأنه كان بحاجة الى مواصلة أعمال الإبادة التي بدأها سلفه.
وتابع حكام فارس القاجاريون هذا التقليد، وأضافوا اليه اللطم والتطبير ليجعلوا منه معادلا نفسيا لسفك الدماء ضد الأقليات الإيرانية.
وعندما دخلت عادات اللطم والتطبير الى بعض البلاد العربية في القرن التاسع عشر لأول مرة، فقد اتخذت كسبيل للتعبير عن الإحساس بالظلم. ولكنها انطوت في الوقت نفسه على شحنات من الكراهية جعلت من سفك الدماء على الرؤوس بمثابة استعداد ضمني لشج رؤوس الآخرين.
وهذا الاستعداد يتكرر في طقس حار وسنوي ليس للتعبير عن "حب الحسين" فقط، ولكن للتعبير عن الكراهية ضد من يفترض أنهم ساعدوا على قتله.
ويحمل شعار "يا ثارات الحسين" تأكيدا لا جدال فيه على الرغبة بالانتقام. ولا يقول حَمَلة هذا الشعار مِن مَنْ يريدون الانتقام. ولكن من الواضح أنهم لا يقصدون الولايات المتحدة ولا إسرائيل، ولا حتى الطغاة أو الحكام الظالمين، ولكنهم يقصدون المسلمين الآخرين بزعم أنهم خذلوا الحسين، ووقفوا الى جانب جيش يزيد بن معاوية ضده في "موقعة كربلاء".
وهم يكررون طقس الكراهية، للانتقام من مسلمين ليس لهم ناقة ولا جمل في تلك "الموقعة". والكثير منهم لا يعرفون لماذا حصلت أصلا.
وخاض الحسين بن علي ثورته ضد الظلم، ولكن "محبيه" يخوضون أعمال القتل والتصفيات باسمه ليس لمحاربة الظلم، وإنما لممارسة وجه آخر من وجوهه.
ورغم أن الذين خذلوا الحسين كانوا من أهل الكوفة وكربلاء والنجف، لا من أهل الرمادي والموصل وتكريت، إلا أن الطائفيين الصفويين، لم يأبهوا في الحرب ضد السنة العراقيين، بهذه المفارقة.
فهم يريدون القيام بأعمال إبادة تكفي لتغيير الموازين السكانية لتعمل لصالح مشروعهم الطائفي. ولهذا السبب اتخذت أعمال القتل والتهجير طابعا جماعيا، ساعدهم فيها المحتلون الأميركيون، وجيش المرتزقة الأجانب، والحرس الثوري الإيراني، فضلا عن مليشياتهم الخاصة.
أما السبب الثاني للسلوك المزدوج فهو "التقية". فالمذهب الصفوي يأخذ بمبدأ "التقية" لكي يسمح لأتباعه قول شيء وفعل آخر.
وظهرت أولى ملامح "التقية" في العصر العباسي. وكانت الغاية منها هي حفظ النفس في مواجهة قمع الخلفاء الذين وجدوا في تطلعات بعض "آل البيت" تهديدا لسلطتهم.
وزال الخطر عندما وقعت الخلافة العباسية بأيدي الفرس. إلا أن "التقية" استمرت، إنما بوجه آخر، لتكون وسيلة للنفاق والدجل والتصرف بوجهين.
والمذهب الصفوي هو المذهب الديني الوحيد في العالم الذي يشكل الدجل جزءا من مقوماته. وهو يُمارس من أعلى المراتب الدينية الى أدناها كشيء طبيعي.
فقد يقول القادة الإيرانيون، على سبيل المثال، أنهم لا يريدون الاحتلال للعراق، إلا أنهم أكثر المتواطئين مع الاحتلال وأكثر المستفيدين منه.
وقد يقول آيات الشيطان في قم، وأتباعهم الصغار في النجف، أنهم مسلمون إلا أن إسلامهم المانوي أقرب الى الوثنية منه الى الإسلام.
وهم يزعمون أنهم يبجلون الرسول محمد (ص) إلا أنهم يُقدّمون عليه علي بن أبي طالب، ويكرهون صحابته، بمن فيهم بعض "العشرة المبشرين بالجنة"، ويتهمونهم بالأباطيل.
وفي احدث الأمثلة على "التقيّة" كانت دعوة رئيس الوزراء الإيراني في العراق نوري المالكي الى مقاطعة إسرائيل بسبب أحداث غزة، بينما كان حبر توقيعه على الاتفاقية الأمنية مع حلفاء إسرائيل لم يجف بعد.
و"التقية" دجل شرعي. ولا تختلف كثيرا عن "زواج المتعة" كدعارة شرعية.
والتواطؤ مع الأجنبي جزء من منظومة ثقافية يشكل الدجل عمودها الفقري.
وهذا التواطؤ قد يكون هو نفسه دجلا على الأجنبي أيضا، في لعبة معقدة يصعب على المرء أن يعرف من أين تبدأ، وأين تنتهي. ولكن الشيء الحصري الوحيد الثابت والمتواتر في هذه اللعبة هو أنها غطاء لكراهية المسلمين السنة.
وأدلة الواقع كثيرة. آلام ومآسي ملايين العراقيين اليوم شاهد صارخ عليها.
ولكن لا يقال أنها تحصل ليس من اجل المال والنفوذ والسلطة، وإنما في "حب الحسين".
فواحدهم قد يمارس من الانتهاكات أبشعها ضد وطنه وأبناء شعبه، إلا أنه يظل متديّنا ورعا في الوقت نفسه.
فبما انه "يحب الحسين"، فهذا يكفي.
وبما انه يلطم عليه ويطبّر من اجله، فهذا يوفر السبيل لاستعادة التوازن النفسي.
يقتل، يذبح، يغتصب، يعذب، ينهب، ويخون، إلا أن إيمانه بآل البيت يظل قويا، ومنه يستمد العزيمة على العودة الى ساحة الجريمة، التي تدفعه بدورها الى أن يكون مؤمنا ولا تفوته زيارة الحسينية.
الدجل إيمان، والإيمان دجل. ولكن المليشياوي الشيعي يفعله حبا في الحسين. وعندما يقتل فانه يهتف بالقول قبل الذبح: "علي وياك، علي"، ليستمد الشجاعة من "حيدر الكرار" على قتل جيرانه وأقرب أصدقائه إليه.
اذهب الى أي مكان في خراب العراق، وستجد أن "حب الحسين" حفرة قهر وبؤس تنز أنينا ودموعا ودماء وضحايا.
اذهب الى وزارة النفط، وستجد أن "حب الحسين" هو الذي يمنح الشركات الغربية الحق في سلب نصف ثروة العراق وفقا لعقود "الشراكة في الإنتاج".
واذهب الى منازل ملايين الأيتام والأرامل والثكالى، وستجد أن "حب الحسين" كان هو الجريمة التي من اجلها تم قتل مليون عراقي.
ولا أعرف كيف يجرؤ أي إنسان لديه ذرة من الضمير والشرف أن يقول انه "يحب الحسين"؟
شخصيا، كنت أحب الحسين، ودموعي تسيل إذا ذهبت لزيارة قبره. ومن ناحية مجرى الدم، فأنا واحد من آل بيته.
ولكن، لم يعد شرفا لي أن "أحبه". عار كهذا يساويك فورا بمليشيات القتل القادم من الشرق. فهؤلاء، على كل ما ارتكبوا من جرائم، يحبون الحسين. وإذا ذهبوا لقتل أبرياء برفقة جون وجورج وسميث، فأنهم يهتفون: "علي وياك، علي"!